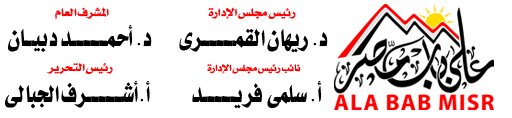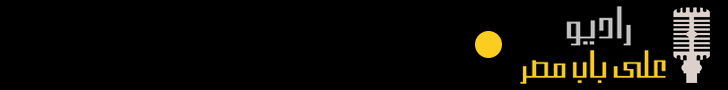“الفراشات تموت محلِّقة” ….ما تيسر من الشعر، وأشياء أخرى للشاعر والإعلامي والمسرحي المغربي “محمد بلغازي” – رؤية الدكتور عبد الحميد سحبان


“الفراشات تموت محلِّقة” ….ما تيسر من الشعر، وأشياء أخرى للشاعر والإعلامي والمسرحي المغربي “محمد بلغازي” – رؤية الدكتور عبد الحميد سحبان

حين تموت الفراشات وهي تحلّق، لا يكون موتُها إلا خلاصا وجدانيا صرفا؛ إذ إن جمالها لا يتلاشى، بل يتناثر في المكان بكل حسنه، في مشهد بلاغي خلاب. في مؤلَّف “محمد بلغازي” نقرأ كتابًا لا يُصنَّف، ولا يستكين لجنس أدبي واحد، بل يعلن عن ولادة نص متميز، يتحدّى القوالب ويستدعي المغامرة. في هذه الإطلالة نحاول التوغّل في عوالم هذا المؤلف، حيث تمتزج الحيرة باليقين، والشعر بالسرد، والمنطق بالعبث.
1- مرة أخرى، إبداع جديد بلا حدود فاصلة بين الأجناس.
“الفراشات تموت محلِّقة”، مؤلف يطرح صعوبة التصنيف، لأنه يضم بين دفتيه ثلاثة أجناس أدبية في الوقت ذاته، شعر، سرد، ومقالة. بالطبع، لم يكن الأول في معترك هذه المغامرة الإبداعية، بل سبقته مؤلفات أخرى. أذكر منها رواية “وجدتك في هذا الأرخبيل” للشاعر “محمد السرغيني”، المنشورة سنة 1992، والتي حيرني أسلوب كتابتها لتداخل الأجناس الأدبية فيها. وقد كانت أول مصنف في مسيرتي القرائية أراه يحطم الجسور بين الشعر والنثر ويمزج بينهما دون اكتراث، لكن الأمر لا يدعو إلى الاستغراب، لأن النص الروائي “ظاهرة متعددة الأسلوب واللسان والصوت”[1].
وقبل ذلك بأعوام، كانت ثلاثية “ذاكرة النَّار” للكاتب الأوروغواياني “إدواردو كاليانو” المنشورة ما بين سنوات 1982 و1986 سباقةً إلى خلط الأجناس الأدبية؛ أعاد به صاحبها تشكيل التجربة التاريخية، لاكتشاف القارة الأميركية زمن تغوُّل الإمبريالية الأوروبية، من خلال تداخل واعٍ بين الأجناس: من سرد، شعر، تأريخ، وأسطورة، ومقالة[2].
لكن بالرغم من كل ذلك، يبقى كتاب “الفراشات تموت محلِّقة”، مستعصيا عن التصنيف، لأن الأجناس الأدبية المضمنة به لم تكن متداخلة متشابكة، كما ورد في المؤَلَّفَيْن أعلاه، بل جاءت متجاورة متساكنة، جزء خاص بالشعر وآخر بالسرد وآخر بالمقالة. مغامرة جديدة قد لا نجد لها تفسيرًا، سوى أنها ميزة ينفرد بها هذا الإبداع الجديد للشاعر “محمد بلغازي”، الذي لم يخفِ ذلك، مصرحا في العنوان الفرعي لكتابه أنه يتضمن “ما تيسَّر من الشعر، وأشياء أخرى”.
2- من “انتحار فراشة” إلى “موت فراشات”
عنوان هذا المؤَلَّف تداعٍ فنّي رفيع، انطلق من “انتحار فراشة”، كقصيدة متميزة من الديوان الأول، “ارتعاشة قمر”، المنشور سنة 2009، لكن النتيجة النهائية، بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة على نشر هذا الديوان، أن الموت لم يكن مفردًا كما هو متوقَّع، بل صار جمعًا. فهل تناسلت الانتحارات؟ أم أن الشاعر انتبه إلى أن هناك فراشاتٍ أخرى أقدمت على الفعل نفسه، ولم يستطع إنكار هذه الحقيقة؟
3- في رحاب مضامين “الفراشات تموت محلِّقة”
وأنا أقرأ شعر هذا الكتاب الذي احتل الجزء الأكبر منه، وفاءً من صاحبه لخطّ تحريره الشعري، طالعتني مرثيَّة امرأة من خلف أسطره. كانت تخفي حزنًا دفينًا ولا تكاد تُبِينُ عنه، وكأن لاوعي الشاعر استعصى عليه طمس بَليَّةِ فقدان زوجته التي غادرته إلى دار البقاء.
جرح على جدار الوجه
حفنة دموع وآهات ….
هذا ما تبقَّى من امرأة،
عند الرحيل.
قدري العودة……
بلا أنثى.
ليست ككل النساء،
طفلة ببراءة خارقة…
امرأة ممنوعة من الصرف،
تصنع الميلاد،
ولا تعود إلى التابوت.

لقد كان شعر هذا المؤلف نابضًا بالإحساس، مُفعمًا بالوجدان، في حين كان سرده منتفضًا، عبثيًا، مشاكسًا، بلمسة كافكاوية لافتة، يمشي فيه المنطق على رأسه بفعل جاذبية نيوتن التي لا فكاك منها. فهل مَن لا يستطيع الوفاء بموعد يضربه مع نفسه؟ وهل من يحتار في العثور على محامٍ لأذنه المضطهدة من شخير جاره؟ وهل الذي يعجز عن التمييز بين مَن ينبح، هل هو صوت الكلب الذي بالخارج أم ارتعاش وجهه الذي تغيرت ملامحه فجأة ليصبح في صورة كلب؟ وهل من يختار لرنَة هاتفه صوت النهيق؟ وهل الذي يتمنى أن يُحبك سروالًا بلا جيوب لفاقته وعوزه؟ كل هذا وذاك، ليس سوى قلب واستقلاب مُحكَم ومُتقن، بحثًا عن المغالاة في العبث والشغب الأدبي الساخر.
4- “ذات زمان” ق. ق. ج من سرديات “الفراشات تموت محلِّقة”
“كنتُ على موعدٍ مع نفسي… أعددتُ العدّة للّقاء… أخذتُ زينتي… حلقتُ ذقني… صفّفتُ ما تبقّى من شعري… ارتديتُ ثيابي الفاخرة… تحقّقتُ من أزرار قميصي… لمّعتُ حذائي… وضعتُ ما تيسّر من العطر… ثمّ توجّهتُ مُهرولًا إلى مكان الموعد… فلم أجدني.”
قصة قصيرة جدًا، تفنَّن صاحبها في التيه بنا في سماء اللامعقول، فكيف لإنسان ألاَّ يجد نفسه؟ إنها ضرب صريح في “كوجيتو” ديكارت: “أنا أفكر إذن أنا موجود”. فبطل القصة فكَّر بالملموس في لقاء نفسه لكنه لم يجدها، إنه الشك في الوجود بعينه، واللامعقول في أعلى مستوياته.
قصٌّ قصير يتماهى مع رواية “التحول” (la Métamorphose) لـ “فرانز كافكا” الذي يصور فيها شخصًا يتحول إلى حشرة ويشعر بالعزلة واللاانتماء… تمامًا مثل شخصٍ يجهّز نفسه للقاء ذاته ثم لا يجدها. وكذلك مع “ألبير كامو” في روايته “الغريب” (L’Étranger)الذي يواجه العالم ببرود، لكنه في النهاية يصطدم بنفسه التي لا تجد ذاتها.
ومن اللافت أن تتطابق قفلة القصة المدهشة مع الروح الشعرية لـ “محمود درويش” في قصيدته “أنا لستُ لي” التي امتلأ حين كتابتها بكل أسباب الرحيل، فيجيبه بطل القصة: أما أنا “فلم أجدني”، بعد أن ضربتُ موعدًا مع نفسي، لقد كانا كليهما في “حضرة الغياب”[3]. ألم يكن بطل القصة يعلم أن “معرفة الذات هي أمُّ كل معرفة” كما ذكَّر بذلك جبران خليل جبران في كتابه “العواصف”[4]. إن البطل لا يمكن أن يستغبينا، فهو على العكس من ذلك، جاد في البحث عن ذاته ليعرفها بتفاصيلها ومعالمها ودقائقها وذراتها، عملًا بما جاء في رسالة سقراط لتلميذه أفلاطون.
5- خِتامُه حيرة
“الفراشات تموت محلِّقة” مؤَلَّف يغلب فيه الشعر على النثر، ويغلب فيه العبث على المنطق في شقّه النثري، أما الشعر فقد ظل وجدانيًا، صادقًا، عاقلًا غير متهور يختزن حزنًا دفينًا على فَقْدِ عزيز.
وللأمانة ينطوي الكتاب في الجزء المخصص للسرد على قصة باللهجة المغربية، غايةِ في الإبداع بعنوان “حيرة الملابس في زمن كورونا”. حوَّل فيها الكاتب ببراعة جمادَ الألبسة المكدسة في خزانة الملابس إلى حياة الحيرة والقلق الذي غلَّف زمن الحجر الصحي داخل المنازل، مبرزًا عمق هذه المعاناة. وإذا كانت الملابس قد احتارت في السبب الذي ألزم صاحبها البيت، وفرض عليه عدم مغادرته إلا لمامًا في زمن كورونا، فإنني وإلى حدِّ هذه اللحظة، لا أزال محتارًا في تجنيس هذا الكتاب.
[1] عن المقال النقدي للدكتور عبد الرحمن بوعلي، بعنوان (الشكل والدلالة في رواية: “وجدتك في هذا الأرخبيل”)، صارد في مجلة “البيان الكويتية” عدد 314، سنة 1996، ص 47 [2] مقال بعنوان، “إدواردو كاليانو: عدو النسيان”، لأسامة إسبر. [3] “حضرة الغياب”، عنوان نص نثري تأملي لمحمود درويش. [4] “العواصف” لجبران خليل جبران، صفحة 93 .