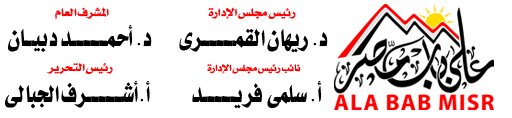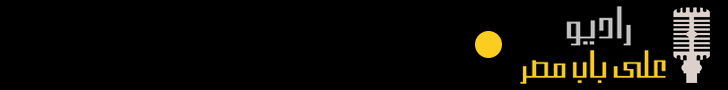“حين تناجي الروحُ ربَّها وتُغري النفسُ صاحبَها ” …. مقال بقلم منى الشوربجي

“حين تناجي الروحُ ربَّها وتُغري النفسُ صاحبَها ” …. مقال بقلم منى الشوربجي

في باطن الإنسان سرٌّ لا يُرى، ونفحة لا تُقاس، ونداء أزليّ يتردّد في سكون القلب: نداء الروح. خُلق الإنسان من طين الأرض، لكن فيه قبسٌ من نور السماء، فصار مزيجًا بين كثافة المادة ولطافة المعنى. وهنا، تبدأ الحكاية الكبرى: حكاية النفس والروح، حكاية الصراع بين الجاذبية الأرضية والحنين إلى الأصل.
الروح، في علوّها، لا ترضى بالدون، تشتاق إلى ما وراء الظاهر، وتسعى إلى منبعها الأول: الله. أما النفس، فهي مرآة تتلوّن، بين أمّارة تلتمس اللذة، ولو في المعصية، ولو على حساب الحقيقة، وبين لوّامة تصحو، وتعاتب، وترجو العودة، وبين مطمئنة سلمت أمرها، فعاشت في سلامها.
وما حياة الإنسان إلا سعيٌ بين هاتين القوتين: صعود الروح وهبوط النفس. في هذا السعي، تُصقل البصائر، وتُختبر الإرادات، وتنكشف الحقائق، ويُفهم المغزى من الشهوة والفتنة، واللذة والألم.
من هنا، ندخل إلى الحديث عن الشهوة، لا بوصفها عيبًا يُدان، بل سرًا يُفهم، وميدانًا يُجتاز، وسُلّمًا قد يرتقي عليه العارفون، إذا سلكوا بنور الروح، لا بهوى النفس.
خلق الله الشهوة، لا لتكون سبيلاً للهلاك، بل لتكون ميدانًا يُبتلى فيه الإنسان، ويتبيّن به جوهره. فهي ليست شرًا محضًا، بل جزء من الحكمة الإلهية في امتحان النفس. ولولاها، لما ظهر فضلُ العقل، ولا تجلّت مراتب الروح.
الإنسان، بخلاف سائر المخلوقات، وُهِب العقل والتمييز والإرادة الحرة. فهو ليس عبدًا لشهواته، بل خُلق ليكون سيدًا عليها. وهنا يكمن الفرق بين النفس الحيوانية التي تنجذب إلى اللذة بلا وعي، والنفس الإنسانية التي تنازعها الروح، وتناجيها البصيرة.
إن لحظات الإغراء ليست مجرد مشاهد عابرة، بل مرايا كاشفة، تُظهر فيها النفوس معادنها. حين تتزين الشهوة بكل ما فيها من فتنة ومَكر، تقف النفس في مفترق الطرق. وهنا يبدأ الصراع بين النفس الأمّارة، التي تهوي بصاحبها إلى ما دون، والروح التي تشتاق إلى ما هو أعلى، والتي همّها أن ترقى بصاحبها إلى مصدرها، إلى العلو الإلهي.
قال تعالى مخاطبًا قوم لوط: “أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون”، أي أتفعلون ما تفعلون، وقد أضاء الله لكم البصائر؟ أتعرفون الطريق، ثم تختارون الانحراف عنه طوعًا؟ إن هذه الآية ليست حديثًا عن معصية فحسب، بل عن خيار وجودي: إما أن تختار ما تشتهي، أو ما تعلم أنه الحق. وهنا، يُفصَل الناس على درجاتهم: كلٌّ يعمل على شاكلته، أي على هيئة نفسه ومقام روحه.
الدنيا إذن، ليست دار جزاء، بل دار تمحيص. وكل لحظة فيها، تُصنّف الأرواح حسب استجابتها لما يُعرض عليها من ابتلاء أو فتنة أو نعمة.
أما الحب، فشأنه أرفع. إنه يُولد أحيانًا من الشهوة، لكنه لا يقف عندها. فالحب الصادق يعرج من ظاهر المحبوب إلى باطنه، ومن جسده إلى روحه، ومن صفاته البشرية إلى الصفات الإلهية التي تسرّبت إليه بلطف خفي.
نحن لا نحب الجمال لذاته، بل لأن فيه مسًّا من جمال الله. نحب الرحمة لأنها من “الرحيم”، ونشتاق إلى الحنان لأنه من “الودود”، ونأنس بالرأفة لأنها من “الرؤوف”. فكل حب حقيقي، إنما هو حب لله من حيث لا ندري. ولهذا فإن الجمال لا يبقى، لأنه ليس ملكًا لمن يحمله، بل هو تجلٍّ عابر، سرعان ما يعود إلى أصله: إلى الله.
وحين يشيخ الجسد وتذبل الصورة، لا يبقى إلا من أحبّ الروح، من رآها وتعلّق بها، من كان ينظر بعين البصيرة لا عين الشهوة. هؤلاء، أهل الله، عرفوا السر، فأراحوا أنفسهم من النزاع، ووجّهوا همّتهم إلى الحق. صاروا يطلبونه في كل مخلوق، ويتتبعون آثاره في الوجوه والظواهر، لكن مقصدهم واحد: الله.
ذلك هو المرتقى الصعب.. طريق الروح الطويل. طريق لا يقطعه الجسد، ولا تحمله النفس الأمارة، بل تسير فيه الروح، مجردة، صافية، تائهة في طلب وجه الله. وصفه يسير، أما سلوكه، فقليل من الناس من استطاعوا إليه سبيلاً.